No hay productos en el carrito.

Benito Pérez Galdós
Verano
Relato
ترجمة إلى العربية: عبد منار المعز أحمد
صيف
1
خرج القطار من المحطة، داهساً بأقدامه الحديدية القضبان الدائرية فكان كمن يريد عن طريق الصخب أن يعبر عن سعادته بالحرية. منه كانت تنبعث زفرات من الدخان مستمرة ومنتظمة شأنه في ذلك كشأن الصبيان عندما يدخنون سيجارة لأول مرة. وفي ذات الوقت كان يوزع على الجانبين بصقات من البخار تماما كشخص صلف أو كجني شقي. بل وصل به الأمر أنه لم يدر رأسه لتحية العاملين على الخط أو السيدات والسادة الذين ملؤوا رصيف المحطة. لقد كان فظاً لا هَمَّ له إلا الابتعاد والاختفاء عن الأنظار تاركاً وراءه المَحال وأرصفة الشحن والتفريغ ومكاتب القطارات قليلة السرعة ومرفأ العربات والورش وكابينة عامل التحويلة.
مر القطار بشاطئ لاكورتادورا، تلك الذراع الخارجة من الأرض والحامية بقبضتها مدينة قادش حتى لا تضيع وسط الأمواج. عند مرورنا هناك رأينا بحر إقليم الليبانتي بمياهه الثائرة وأفقه الغائم، كانت تلك منطقة معركة الطرف الأغر. وعلى الجهة الأخرى رأينا الخليج الذي استقرت على شواطئه مدن وضواحي متبسمة فرحة. رأينا أيضاً مدينة قادش التي كانت أرضها تنثني ببطء كراقصة بوليرو مُنهكة، بدت لنا بضفتيها الشرقية الغربية المتطابقتين.
ثم وطئ القطار البرك المالحة للجزيرة فاتحاً طريقاً له بين جبال من الملح، فاجتاز القنوات الشهيرة لهذه الجزيرة: القنوات التي على حدودها حسمت إسبانيا وفرنسا نزاعاتهما الأخيرة. ثم عبَر القطار المياه الشهيرة التي على صفحتها طفت عباءة آخر ملوك القوط، ثم ما لبث أن توجه القطار نحو الداخل مسرعاً بخطاه المتحمسة.
بلا شك كان القطار يجري مسرعاً لانجذابه للرائحة المثيرة لأقبية خمور مدينة شريش التي كان يقترب منها مع كل دقيقة تمر. في النهاية أصدرت الآلة القلِقة شخيراً مدوياً، ثم تشممت الهواء المحيط بالمكان كما لو كانت تريد أن تستنشق رائحة العصير المٌخزّن بين الجدران القريبة. ثم توقفت.
وجدنا أنفسنا في أعظم حانة عرفها التاريخ، فقد كانت تعج بأكثر المشروبات جودة ولذة وقوة. عند الوصول إلى هذه النقطة من الكرة الأرضية لا يستطيع المسافر إلاً أن يتأثر بالمشهد: حقل معركة جليل نثرت فيه رفات وبقايا فضيلة الاعتدال بعد أن هزمها وقضى عليها تماماً عدوها الرائع، ليبعثر بكبريائه العتيد على ساحة المعركة غنائم تبرز انتصاره. فحياة ملايين الأشخاص أصبحت سماداً للأرض المكللة بأشجار الكروم الخضراء وارتفعت أكوام من البراميل المكدسة أو تدحرجت كسكارى بلا عقول. لم يكن هناك سوى الضجيج والنشاط والدوار.
لم يكن من الممكن مقاومة إغراء الخمر، بلونها الذهبي ومذاقها الحاد الذي يشبه تجرعه ابتلاع شعاع من أشعة الشمس. إنها الخلاصة المطلقة للحياة، فجزيئاتها المضيئة تحمل معها القوة و الذكاء والسعادة والنشاط، وعبيرها الرقيق يشبه البشرى السعيدة، مذاقها يحفز الوعي في الجسد. تخدع الزمن وتطمس السنين وتخفف الهموم التي تحني أجسادنا المنهكة. تحمل في طياتها روحاً قوية تتحد مع أرواحنا فيُكَونون معاً روحاً ملائكية قد تتحول إلى شيطانية إذا تَمَلَّك التكبر منها.
لقد كنت من هؤلاء المفتونين، وقبل أن يتحرك القطار عبأت جسدي بأشعة الشمس. ثم تأملت لاحقاً بإعجاب أشجار الكروم، تلك الأم المبجلة لقاهر الأمم الشهير. حدث ذلك عندما شعرت بأحد يلمس كتفي، دهشت، فقد كنت أظن أنني وحدي في العربة. التفتّ بسرعة و

2
… بالفعل، كانت امرأة، أقصد أنني عندما التفتّ رأيت امرأة.
عند الخروج من شريش كنت وحدي في العربة، إذن فكيف ومتى ومن أين دخلت تلك السيدة؟ كان ذلك أمراً صعب التفسير، خاصة – ويتوجب علي الاعتراف – أنني لم أكن أتمتع بصفاء ذهن كامل.
–سيدي …
تلت كلمات أخرى هذه الكلمة، لكني لم أستطع فهمها جيداً. يُهيأ لي أنى أجبت:
–سيدتي …
إلا إنني لست متأكداً مما تمتمت به شفتاي الثقيلتين بعد ذلك، أغلب الظن أنني قلت عبارة مجاملة ما للسيدة. بالتأكيد كنت مشوش الذهن ولا أعرف لهذا سبباً آخر غير ذلك العصير الذهبي اللعين الذي أودعته في جوفي.
وجدت نفسي مقتضب القول شارداً، ساعد بشدة على ذلك مظهر السيدة الفريد، فلم يحدث أن رأيت مثله قط. أذهلني بصورة أعجز عن وصفها كنه السيدة وثوبها، ذلك الثوب الذي لم أستطع أن أبعد عيني المشدوهتين عنه. في الحقيقة ليس من السهل تخيل ملابس أكثر غرابة: غرابة لا تكمن في ثوب السيدة المبتكر، بل في عدم وجود ثوب من الأساس.
أعتقد أنني قلت –بكلمات متقطعة ووجه مصبوغ بحمرة الخجل وعينين هاربتين من النظر إليها–:
–سيدتي، فلتتكرمي بارتداء أي شيء، فإن هذا الثوب، أو بالأحرى هذا العُرى، ليس مناسباً للسفر في وضح النهار داخل عربة قطار سكك حديدية.
انفجرت السيدة في الضحك. كان جمالها يفوق جمال البشر. أكاد أتذكر أنه سبق لي رؤيتها في صورة ما، لا أعرف أين، أفي جدارية من جداريات الفنان رافائيل، أم في مشروع نقش بدائي أو رسم ما؟ أفي لوحة «الساعات» الشهيرة، أم في نحت من أعمال ثورفالدسين، أم تراها في تلك المنطقة الغامضة التي يسكنها الخيال الخلاق لأقطاب الفن؟
لا شيء مما صاغه اليونانيون أو مما نحته الفلورنسيون يمكن أن يعلو في جماله على بنية جسدها التي لا مثيل لها. كانت قسماتها كقسمات حوريات البحر والبر متطابقة في هذا مع المقاييس الكلاسيكية للجمال. بل كانت تشبه آلهة الزمن الماضي، بل رموز الأمومة والعطاء اللاتي من خلالها وعلى الأسقف المُذهّبة انعكس الفكر الإنساني طوال قرون.
لم أرَ في حياتي جمالاً بهذا الكمال، ومع ذلك لم يكن من السهل تأملها، فعيناها كانتا الشمس نفسها، تخطف الأبصار ثم تؤذيها وتحرقها فيفقد الناظر إلى تلك الصورة الفاتنة بصره ما لم يحتَمِ بنظارات شمسية.
وعن شَعرها لن أقول سوى إنه بدا لي كخيوط أنقى أنواع ذهب الجزيرة العربية، ومنه فاح عبير ريفي قوي، وتشابكت فيه زهور شقائق النعمان مع سنابل القمح في إكليل رائع. أما رداؤها فكان كعباءة معتمة مثل الضباب الكثيف القريب من الأرض الذي لفها ساتراً أو كاشفاً أجزاء من جسدهاً مع تغير الأوضاع التي تتخذها.
لم يكن لدي علم بتلك الطريقة الفريدة للظهور في المجتمعات، لكنني أقر أن مظهر السيدة النبيلة رفيقة رحلتي بدا لي فاضحا وجريئاً منذ الوهلة الأولى. بيد أن مرور بضع دقائق أخرى راقبتها فيها كانت كفيلة بأن تغير حكمي لصالحها، ففي حسنها الملائكي وسلوكها اللطيف العفوي وكلماتها وحركاتها تألقت العفة الكاملة واللياقة الشديدة.
3
لكن السيدة -إن لم تكن النار بعينها- فقد كان لها نفس الأثر: فجسدها كان ينضح عن حرارة خارقة حتى أنني منذ دخولها الغامض إلى العربة بدأتُ في التصبب عرقاً كما لو كنت في غرفة حرق الفحم بالقطار.
–سيدتي،– تحدثت إليها بكل احترام، مجففاً عرق وجهي الغزير– اسمحي لي بأن أبتعد عنك قدر الإمكان لأنك القيظ ذاته متمثلاً في جسد وروح.
ابتسمَت بطيبة وعرضت علي مروحة بعد بحث دؤوب في مخلاة كانت تحملها على ظهرها. لحسن الحظ كنت أضع نظارات ذات زجاج أزرق استطعت بها أن أحمي عيني من لهيب السيدة.
على رغم من ذلك، زادت الحرارة التي تشعها رفيقة رحلتي حتى أنى كسرت المروحة عفواً من شدة التهوية بها محاولاً سدىً أن ينعشني هواؤها. حدث ذلك عندما اندفع القطار مسرعاً بين السهول الموجودة على يسار العربة لنهر الجواد الكبير.
كانت المناظر الطبيعية التي مررنا بها لافتة للانتباه أحياناً وغير ذات أهمية في أحيان أخرى، لكن في كلتا الحالتين اجتاحني الضجر. كانت أشجار الأرز تتراقص أمامي في دوائر مُدوِّخة، وكانت أشجار زيتون مدينة أوتريرا تسير في صفوف مغلقة كالجيوش المنتظمة المتوجهة إلى أرض المعركة. كلها كانت ألعاب بصرية لم تستطع أن تخفف من انزعاجي وضيقي، كما لم ينجح في ذلك المشهد المتنوع لمحطات القطار التي مررنا بها أو الوصول المرتقب لمدينة اشبيلية التي لاحت لنا من أبعد نقطة على مرمى بصرنا ببرجها الشهير «لا خيرالدا».
استقبلتنا أخيراً أشبيلية بأسوارها اللاعجة الحارقة كقدور مُحماة فوق النار. كانت المدينة البهيجة راقدة تحت آلاف المظلات المنزلية، تحاول أن تغفو في أفنية المنازل ذات الهواء الرطب المنعش. وكانت مئات من أبراج الكنائس –التي تعلوها السيدة البرونزية هوائية المزاج والتي تلف 122 بارت[1] حول الأرض– تصطلي بالشمس الثائرة تماماً كالآثمين الذين بدلاً من أن يهبطوا إلى الجحيم لتلقي الجزاء صعدوا إليه.
لم أستطع أن أمنع نفسي من الحديث وقلت للسيدة:
– أظن أنك ستنزلين في هذه المحطة التي تتناسب بشدة مع مزاجك الحار.
– لا يا سيدي–، أجابت بخجل فتاة بتول، –أنا ذاهبة إلى مدريد.
في قولها هذا كانت تقترب مني، فاجتاحني شعور مباغت أنني موشك على الاحتراق، فقد تحولت حرارة ذلك الجسد الغامض للحورية الشيطانية إلى لهيب.
– سيدتي، سيدتي، أستحلفك بالله–، صحت، –من المؤلم بشدة أن يضطر سيد للهروب، سيكون ذلك فعلاً فظاً وأهوجاً، لكن…
بالفعل، كنت لأرمي نفسي من شباك القطار لو لم تمنعني سرعته. لكن لحسن الحظ أن نفس السيدة التي كانت تحرقني بلا رحمة قدمت لي بعض المرطبات التي لا أعرف من أين أتت بها مما ساعدني على تحمل أنفاسها الكاوية وذلك البخار الجحيمي الخانق الناضح عنه جسدها الفتان.
حينئذ كنا نمر بالإقليم السعيد الذي يتوسط الأختين الأندلسيتين الشهيرتين المستقرتين على جانبي النهر المزهر، بين أشجار البرتقال والزيتون. وكنا – كل فرسخين أو ثلاثة- نلقي التحية على قرية من القرى الصديقة مثل لورا وبِنيافلور وبالما.
وعندما اقتربنا من قُرطبة تغلب شعوري المتنامي بالحرارة الخانقة على صبري، إذ أصبحت رأسي تغلي وصارت دمائي كمعدن مصهور، فقررت التخلص من الرفيقة المزعجة التي تلازمني منذ مدينة شريش. وما إن توقف القطار حتى سارعت في تجميع أفكاري لأشرح الأمر لعمال السكك الحديدية.
لا أعرف لماذا ضحك هؤلاء الملاعين عندما سمعوا شكواي وقضيتي العادلة. قد يكون السبب أني تحدثت بجمل مشوشة غير مرتبة. لكنى كنت أوشك أن أنفجر من الغيظ من موقفهم هذا، حتى أن مدير المحطة ظن أنني مجنون عندما قلت له:
– نعم يا سيدي، أؤكد لك : في عربتي امرأة تطلق اللهيب من عينيها والحرارة الحارقة من جسدها. على راحتَي يديها يمكن أن تُشوي شرائح اللحم ويُقلي السمك. لا يجب أن يتم السماح بذلك مطلقاً. إنه تجاوز وجور، فضيحة. سأقدم شكواي لناظر المحطة، بل للمحافظ، بل للحكومة نفسها.
حرّكهم الفضول أكثر من أي شيء آخر وذهبوا ليعاينوا الكابينة حيث كانت السيدة. رأيتها. كانت هي بعينها، بلا أدنى شك. لكن اختفت تلك الثياب الخفيفة التي لفتت نظري بشدة وحل محلها ثوب من ذلك النوع المعتاد الذي ترتديه النساء في بلدنا. لم تعد عيناها اللعوبتان تخطفان الأبصار، اختفى من جسدها أي أثر للحرارة الكاوية التي كان يصدرها، وكانت تضع على رأسها القبعة الدارجة المزينة بسنابل القمح.
كانت أنيقة بلا تكلف في تلك الهيئة البسيطة العادية.
4
تأملتها صامتاً مُشَوشاً. وبالطبع طرقت كل أبواب الثناء عليها والاعتذار لها، معزياً ما اقترفته من خطأ فادح إلى عقلي الغائب.
ولكن ما إن بدأ القطار في السير نحو السلاسل الجبلية حتى عادت السيدة لمظهرها السابق: نفس العُري، نفس العباءة البخارية الخفيفة، نفس السنابل الريفية في شعرها الذهبي، نفس العيون المستحيل النظر فيها ونفس الحرارة الحارقة المنبعثة من جسدها اللافح. ولكن هذه الحرارة تحولت الآن لتصبح قيظاً استوائيا قاسياً، بل إلى نار تصهرني كما لو كنت شمعة.
أردت أن أقفز من العربة، أن أُنادى، أن أصرخ، أن أطلب النجدة، لكنها منعتني.
انقطع نفسي، خارت قواي، غرقت في عرقي، اختلت بعنف قدراتي ووظائفي الحيوية، فقدت الوعي بكل شيء، اغتام إدراكي وحكمي على الأشياء، وبالكاد استطعت أن أصيغ هذا التفكير المحتضر : «إنني في غلايات الجحيم».
وعندما كنت على شفا أن أكون جثةً هامدة، مُلقَى على الوسائد ومتشوق للهواء، اقتربت مني تلك الكائنة الشيطانية، أمسكَت برأسي وأعطتني خمراً ما منعشة لذيذة فساعدت رئتيّ على العمل، ونشرت بعض البرودة في أنحاء جسدي. وعندها تحسنت حالتي هدأت أعصابي المضطربة فحظيت يبعض الاسترخاء.
ثم عندما استعادت حواسي وعيها استطعت أن أستمع للحديث الذي توجهت إلَي به بصوتها العذب. وإن لم تخني ذاكرتي كان كلامها على النحو التالي:
5
– أنا اكتمال الحياة، أنا قمة السنة الطبيعية، أنا قانون النضوج الذي يسمح بتمام كل الأشياء، أنا تنفيذ المحاولات التي تنبض في جوف الطبيعة اللامتناهي.
قبلي كل شيء بذرة صغيرة. بعدي كل شيء يذبل ويموت. أنا الإنجاز الأعلى. أنا النصر البديع للقُوى المتعددة التي تحارب الموت: أنا الثمرة. بي يعيش كل كائن حي، وبدوني كان الكون سيصبح صرفا ًمن التثاؤب الأبدي أو ضجر قُوى الطبيعة عندما ترى نفسها بلا هدف، بدلاً من أن يكون هدفها المجد والنجاح.
أنا عند الرجال مرحلة الإدراك والتمييز والانجاز، وللنساء أمثل فترة الخصوبة والحب، وللطبيعة أنا تطور ونمو كل المخلوقات التي عندما تصل لمرحلة البلوغ تتكاثر بينها، فتكتشف في تلك العظمة جُود وكرم الخالق الأعظم.
إن شعري الشمس وعيوني النور وجسدي البيئة الدافئة التي تمنح الوجود عند مرورها. ظلالي الندى الذي به تبدأ الحياة الجديدة، وحجرتي السماء بإيقاعاتها الباهرة، وعرشي الذروة. أنا النضج الكوني.
توجهني يد الله في دورتي المستمرة. عندما أظهر يكون كل شيء جاهزاً. يكفي أن أبتسم كي يمتلئ العالم بالثمار. ينتظرني المزارع بشوق لأن رضاي أو غضبي يحددان رزقه، فأنا أهديه حقول ومحاصيل وثمار وافرة، وأبشره بعصير العنب الذي يملأ مخازنه وأضاعف ماشيته وخلايا النحل لديه.
أٌزيد من الثروة السمكية لصائد الأسماك، وأهدي العامل ساعات نهار أطول، وأخفف من سقم المريض، وأعطى البهجة للمُعافى. للغنِي أمدّه بالبسطة وبالزيادة وللفقير السلوى.
يحتفل بقدومي البشر على كل عروقهم وأنواعهم. فالذين يفلحون الأرض يحتفلون بأعيادي الشهيرة المخصصة للتجارة والصداقة والولائم الريفية والأعراس المبهجة. فأيام ومناسبات مثل سان أنطونيو وسان خوان وسان بيدرو والكارمن وسانتياجو وسانتا أنا وسان لورينثو ولا بيرخن دى أجوستو وسان روكى ولا بيرخن دى سبتيمبري هي بالترتيب وبالتقويم الميلادي تواريخ تعكس انتصاراتي. أيامي خصبة تتضاعف فيها الحياة لأني أُحفز العواطف وأنعش الرغبة عند الرجال وأزيد من حماستهم حتى أدفعهم للقيام بالأفعال الأكثر جرأة.
يتهمونني بالتحريض على الثورات وإثارة الشعوب ملوحة براية التحرير الحمراء بين يدي المتقدتين. ينكرون علي تدخلي في بعض الانتصارات الشعبية، لكنني فقط، ودون أن أطلق الأحكام على هذه الانتصارات، أقر أنى أسقطت قلعة الباستيل، وقوضت قاهر أوروبا[2] ودمرته في مكان ليس ببعيد عن الأماكن التي نمر بها الآن، وأنى هنا أيضاً أنقذت العالم المسيحي من أنصار محمد. أنا التي أبطلت محاكم التفتيش الاسبانية. أنا التي صددت الأتراك وأوقفتهم عند أبواب فيينا. أنا التي حققت آلاف وآلاف الانجازات العظيمة التي لا يمكن حصرها، فهي أكثر من لفات عجلات قطار رحلتنا الذي يجري بنا مسرعا.ً
6
حقاً كان القطار يجري مسرعاً مجتازاً وتاركاً وراءه سلسلة الجبال الوعرة الماثلة هناك كحائط لقشتالة.
حل علينا العصر بوداعة، ومع تقلب السماء كانت السيدة تلطف من حرارتها غير المحتملة مثل الجمرات التي تنام وتنطفئ وتموت في كور الحداد.
نعم كانت عيناها ما تزالان تبرقان ولكن ليس بوهَج الشمس بل بنور أبيض مثل ضياء القمر. من جسدها انبعثت رطوبة خفيفة تحولت شيئاً فشيئاً لتصبح برودة لطيفة. وبهذا بدأت الإلهة المنفرة – التي كان الاقتراب منها خانقاً– تتبدل لتصبح الكائن الأكثر جمالاً ولطفاً كما لم يخطر على عقل. وكان كل شيء يدعو إلى السكون والاستلقاء بجانبها بأريحية واسترخاء ومراقبة مرور الساعات والأفلاك واستشعار مرور الهواء الغني بالعبير.
نظراتها أدخلت في نفسي شرود لطيف، فقد رأيت في مقلتيها ما يشبه الانعكاس الفضي لبحيرة هادئة، وابتسامتها أغرقتني في بحر من النشوة، و في شفتيها رأيت بوابتين سماويتين تتفتحان.
وهكذا قضينا الليل كله: عابرين من طرف إلى آخر الأرض الطيبة التي شهدت المعركة الخيالية بين المثالية والمادية. إلا أن الليل لملم ظلمته ليهرب في الوقت المناسب، لتخرج علينا الأشجار الأولى لمدينة أرانخويث كى تحيينا وتستقبلنا بمكان ليس ببعيد من نقطة توقيع نهري التاخو والخاراما لاتفاق الصداقة بينهما.
وأخيراً بعد رحلة طويلة من الجري والصفير، وبين التراب والضوضاء، وصل القطار إلى مدريد، حيث لم تُرِد رفيقة سفري – التي تعلقت بي بشدة– تركي، فاستقلَّت معي السيارة واستقرت في حجرتي وجلست معي على المائدة بعد أن عادت مرة أخرى إلى حالتها الأولى: أي العُري الحارق الذي كانت تظهر به أمامي فقط، لكنها حافظت على ذلك السر الذي كان يجعلها خفية لجميع الناس ما عداي.
في الصباح جعلتني أتصبب عرقاً، وكنت أختنق بمجرد اقتراب أناملها المتوهجة مني. لكن عند حلول الليل استعادت هيئتها المنعشة واللطيفة فبلغت في نفسي مبلغ الصداقة العميقة التي لم أستطع أن أهبها لهيئتها المُشعة كضوء الشمس.
وأعجب ما حدث أنني عندما دعوتها إلى الغداء في حدائق الريتيرو كشفت السيدة الكريمة فجأة عن حيل سببت لي حالة عميقة من القلق والاضطراب: ففي منتصف الطعام بدأَت في تحريك الكؤوس وتفريغ الزجاجات في سرعة مذهلة متذرعة بطبيعتها التي تقتضي منها ذلك حتى أني آمنت بأنها ليست سيدة وقورة بل امرأة عابثة لاهية.
7
لم نكن قد انتهينا من الطعام عندما بدأت السيدة –التي تغيرت كُليةً بسبب كميات ذلك المشروب الذي أودعته بين صدرها وظهرها–في القيام بتصرفات غاية في التهور والطيش: بدأت بتحريك كفّي يديها كالمروحة فهب هواء وجاف وساخن بل حارق. ثم انفجرت في الضحك بقهقهات مجنونة مدوية فسقطت أمطار مريعة أساءت لمرتادي ذلك المكان الجميل بشدة إذ أجبرتهم على التفرق. ثم جرت بعد ذلك فصارت كالرياح العاتية فتكسرت المصابيح الزجاجية وارتفعت تنانير السيدات وانتُزعت قبعات الرجال ومُزقت ستائر المسارح وانحنت الأشجار وتأوهت الأغصان وغطت أوراق الأشجار مصابيح الجاز.
لم أرَ في حياتي فوضى بهذا الجنون ولا رعب بهذا الهول ولا اضطراب وبلبلة بهذا الحجم . كم كانت اللعينة تضحك عندما رأت هذا الدمار، كنت أحاول تهدئتها إلا أن ذلك كان مستحيلاً، خفت أن يتم اقتيادها إلى قسم الشرطة بسبب أعمالها الشيطانية لكن الماكرة كانت محظوظة كأمثالها من الخبثاء، فلم يرها أي شرطي.
بعد أن أطلقت تلك المخلوقة على مدريد الأمطار المباغتة التي أزعجت بشدة المشاة، نفخت يميناً ويساراً فأطلقت برودة جافة وبغيضة جعلت الأبدان تقشعر فرفع الجميع ياقات معاطفهم الخفيفة وتلحفوا بالمناديل التي كانت الشيء الوحيد المتاح بين أيديهم. هرع أهل مدريد إلى منازلهم وغمغموا هامسين : «ما أبغض هذا الطقس، ملعونة هي مدريد وكل من يقرر أن يجعل مقر الحكم فيها.»
نفس الشخصية بطلة كل هذه الكوارث تنقلت تلك الليلة بعباءة، ساخرةً من رجال البلاط ومن غضبهم. لم أستطع أن أمنع نفسي وواجهتها بسلوكها قائلاً أن تلك أفعال تخلو من التهذّب وأنها لا تليق بشخص مستقيم، فليس من الأدب إزعاج الآخرين وتعكير صفوهم في هذا اللهو المشروع.
فانفجرت في الضحك مرة أخرى وقالت إنه لا يمر أسبوع في مدريد إلا وتقوم بهذا النوع من الدعابات الثقيلة، فبهجة العاصمة وروح الفكاهة الدائمة بها تشجع على ذلك. لهذا لم تستطع مقاومة إغراء القيام ببعض المقالب: فسعدت بإفساد الحفلات عندما غيرت الجو وبدلته، وابتهجت بإطلاق برودة الشمال بعد ساعات طويلة من الجو الخانق، وتسلًت بشدة عند رؤية تبرٌّم أهل مدريد.
وقالت إنها عندما لم تستطع أن تمتنع عن التردد على المآدب والولائم الفاخرة وحفلات اللهو اضطٌرت للشراب فلعبت الخمر برأسها واقترفت أكثر التصرفات جنوناً دون أن تدرك ذلك.
قلت لها إني سأودعها إذا تكررت ألاعيبها السخيفة. لكنها سخرت من غضبي وأجابتني بأن اليوم التالي ستكون الحرارة أكثر اعتدالاً.
وهذا ما حدث: استقللت القطار المتجه من بلدة بييًا دييجو نحو الشمال، والذي أخذته من محطة القطارات الرئيسية في مدريد الموجودة في سفح جبل برينثيبى بييًو. لكن القطار لم يسر أكثر من مترين إلا وقد صعدت إليه رفيقة سفري وصديقتي، وجلست بجانبي.
8
– ستكون مدريد سعيدة – قلت لها– إذا غادرتها.
– لا، لأني تركت هناك مندوبين عني، وهم مثلي تماماً.
أستميحكم العذر في أن أقول أن السيدة التي تبدلت ليلاً كانت رفيقة سفر من ألطف ما يمكن. فمن وقت لآخر كانت عينيها تشعان بريقاً أزرقاً ضارب إلى السواد مما جعلني أضطرب إلى حد ما، لكن الأمر لم يتعدّ ذلك، وعلى الضوء الذي كانت نظراتها تنشره في كل المكان رأيت الإسكوريال، صرح كالجبل مبني عند سفح جبل آخر. رأيت أشجار الأرز المنتشرة والتي ذكرني تراقصها المتناغم بأشجار الزيتون في الأندلس. ثم اجتزنا سلاسل الجبال المرتفعة حيث تركت القديسة تريسا في نهايتها ذكراها الخالدة عند بيت ريفي مُسوًر يشبه الآن كومة من الأطلال.
مررنا بمدينتَي أريبالو ومِدينا وبصوامع الحبوب وأمجاد قشتالة التاريخية، ورأينا على الأرض التبن اللامع المفصول حديثاً عن الحَب. مررنا بالقرى النائمة التي لم يستطع القطار بجلبته أن يوقظها. وعندما توغل الليل وأطبق السكون على الحقول، فصارت قاطرتنا الكبيرة ذات المفصلات ككلب ضخم أسطوري يجري نابحاً من مقاطعة إلى أخرى.
على يسارنا كانت مدينة بايادوليد النائمة، مظلمة وكبيرة وجليدية، يداعبها حبيبها نهر البيسويرجا الذي يتوق لايقاظها ولكنه بالكاد يستطيع.
ثم اجتزنا كرمات العنب النضرة والحدائق الغنًاء لبلدة لدوينياس البدائية ساكنة الكهوف. ثم لاح بعد ذلك بقليل نُزل بينتا دى بانيوس المُشيد على أرض صحراوية في ملتقى السكك الحديدية. ثم انحرفنا قليلاً نحو اليسار وعرجنا نحو مدينة بالنثيا التي كانت الشمس قد غمرتها دون أن تنزع عنها العباءة الترابية التي تغطيها. وعبرنا البراري التي شقتها المحاريث من أقصاها لأقصاها، كانت جافة ومسطحة تماماً ولاعجة، كخريطة كبيرة مرسومة على سطح جاف خشن. لم تُغرِ هذه الأرض أي جبل-كبر حجمه أو صغر- كي يستقر بها، ولم يخترها أي نهر متدفق ليمر فيها، كما لم تشأ أي غابة أن تغرس فيها جذورها.
وبعيدا، كانت هناك أنهار وبحيرات تعكس صفحتها صفوف من أشجار الحَوَر مبشرةً بالأجواء المعتدلة عند الجبال التي كانت تقترب منا والتي مر القطار بمرتفعاتها الأولى دون أن تعترضه الصخور أو برك المياه. وبعد أن تغلب القطار على الجزء الأكبر من هذه الجبال التي دعته إلى الارتفاع أكثر، اجتهد القطار في الصعود إلى بلدة رينوسا، جارة السحاب المغطاة بالغيام، ونجح في ذلك.
هناك، بعيداً، كان جبل نافر غير مستأنس يصر في عناد طفولي على أن يمنعنا من التقدم. وعقاباً له على هذه الوقاحة عبر القطار من خلاله كالإبرة في النسيج.
كل شيء بعد ذلك كان وعراً وخشناً: غابات في طريقها للانقراض والزوال تتمسك جذورها الملتوية بالأرض والصخور، جداول تسرع في الهبوط صارخةً كالصِبية عند خروجهم من المدرسة.
وقبل ذلك رأينا – متجهاً نحو الجنوب- البيسويرجا -ذلك الخيط الضئيل والبائس من المياه – وهو يقوم بالتفافات والتواءات أكثر من تلك التي يقوم بها شخص مخمور. كما رأينا – متجهاً نحو إقليم الليبانتي- الإبرو: النهر الذي يولد طفلاً ليتحول لاحقاً إلى رجل.
سرنا بمحاذاة المياه المتجهة نحو الشمال. وبعد الخروج من ذلك النفق الذي يشبه الكابوس ظهر لنا على اليمين طفل صغير مشاكس يسير بجانبنا يلعب ويقفز ويقوم بحركات بهلوانية ساخراً من الأحجار وجذوع الأشجار التي يقابلها في طريقه. كان ذلك البيسايا: نهر متواضع رافقنا لمسافة طويلة. وفي سيرنا عبر طريق الهبوط الصعب لجبال كانتابريا المدرجة كان ذلك النهر الشقي يهبط وثبا معنا، حتى رأيناه في الأسفل ضاحكاً لاعباً. لكنه لم يرد أن يتركنا، ففي بلدة بارثنا دي بييى دي كونتشا غَيّر مكانه ليصبح على يسارنا. وأثناء مرورنا بكل الوديان والمنخفضات الضيقة كان يسلينا ويرافقنا ويحاورنا بأسلوب كله تهذيب وبساطة.
وفي مضيق مفروش بزرع أخضر يانع رأينا بلدة لاس كالداس، كالوعاء الكبير بين جبلين. وبعد أن اخترقنا الجبال واجتزنا الوهاد، وصلنا لوادٍ فسيح و جميل. وهناك ودّعَنا السيد بيسايا بأدب واحترام، لأن صديقه نهر الساخا كان ينتظره عند بلدة تورًيلابيجا ليذهبا معاً للاستحمام في مياه البحر. فشكرناه على عنايته و واصلنا الرحلة.
كانت المروج الخضراء والنقية لا تقارن في جمالها بأي شيء آخر، فغابات من أشجار الكستناء امتدت فيها، وبجانبها تتمتع الأنظار والأرواح بنضارة الحدائق الغنًاء وحقول الذرة الوارفة. ثم عبرنا –بين القضبان– نهر كبير يسمى نهر الباس، وبعد ذلك بقليل شممنا رائحة البحر. بلا شك كان قريباً، وكان فقد بدت بوادره في الغدران المنتشرة في غير انتظام، مثل الأصابع المتشابكة. ثم رأينا يديه اللتين تقبضان على الأرض، وفي النهاية شاهدنا ذراعه الضخمة التي تمتد بين سلسلتين جبليتين.
9
ورفيقة سفري؟
اختفت الظواهر الجوية الحارة (التي أوغرت صدري تجاه تلك السيدة) منذ أن وصلنا إلى هذا المكان، أو بالأحرى منذ أن تركنا تلك السهول القشتالية المضجرة.
خفُت بريق عينيها المزعج كأن غيماً خفيفاً قد قلل من ذلك اللمعان. وتوقف جسدها الفاتن عن إخراج النار مثل كور الحداد، فاستطعت أن أقترب منها بحرية و–بعيداً عن الحرارة القاسية– شعرت بدفء عذب ينعش الروح والجسد.
استيقظ في نفسي فجأة ميل قوى نحوها. تحدثنا، وتشجعت كلماتي عندما أضفت إلى حديثي كلمات الغزل، وحَوًجته بالتنهدات. وزادت شجاعتي فداعبتها، وزادت شجاعتي و أخذتني الحماسة فاعترفت لها بمشاعري وطلبت يدها.
يا بن آدم، أأنت فانٍ لأنك ضعيف أم أنك ضعيف لأنك رجل؟
اقتادتني الماكرة لمكان بهيج بالقرب من المحيط تملؤه الخضرة والزهور يسمى ساردينيرو. جمع هذا الشاطئ بين دفء الأرض وهواء البحر، كان كحديقة لها شاطئ على البحر ورمال ذهبية حيث تمتد الأمواج الكسلى لتجعل الشمس تتمطى، وجبل صغير ساحر، ربيعي الطقس، جامعاً لكل مفاتن الطبيعة.
في البحر أنزلتني رفيقتي –التي أسميتها زوجتي منذ تلك اللحظة– (لأنها وافقت على ذلك، وإن كان رضاها غادراً)، ثم دعتني بعد ذلك للنزهة والطعام.
ما أجمل الأيام التي قضيناها معاً، وما ألطف لياليها. كم كانت تدور عجلات الساعات بلا أن تسمع خطاها على تلك النجيلة المزهرة أو على رمال الشاطئ الحنونة. لقد كنت أسعد رجل فى الكون. إلى أن جاء يوم… يا لشؤم هذا اليوم
لم أكن قد رأيت رفيقتي بهذا الجمال ولا بهذا السرور ولا بهذا اللطف…
سبحنا معاً مستمتعين بملاطفة الأمواج، متشابكي الأيدي، ناظرين كل منا للآخر. وفجأة اختفت، لا أعلم كيف ولا إلى أين. تركتني في ذهول يملأني اليأس.
بحثت عنها في كل حدب وصوب، في المياه وخارجها. لم أجدها في أي مكان. انفجرت في البكاء وشعرت بالبرودة، برودة وصلت حتى عظامي واخترقتها.
كان يوماً حزيناً، بل يوماً تعيساً، بل يوماً فظيعاً. أتذكره جيداً: يوم 22 سبتمبر.
[1] اسم مقياس طول يساوى 835 ,0 م. (المترجمة).
[2] الجيش الفرنسى بقيادة نابوليون بونابارت، و قد هزم فى معركة بايلين “Bailén” فى 19 يوليو 1808. (المترجمة).




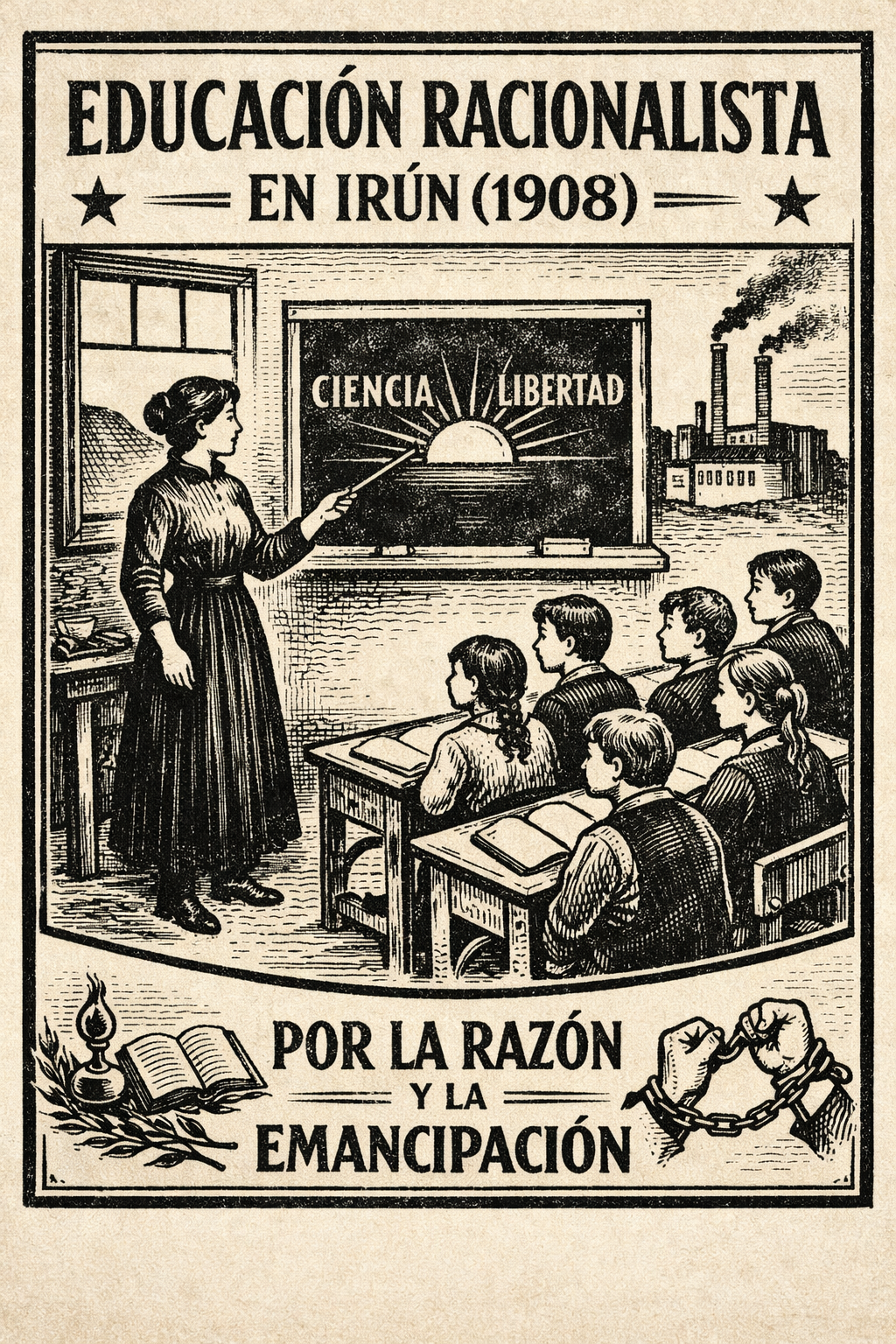











What i don’t understood is actually how you’re not actually much more well-liked than you might be right now. You’re so intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, made me personally consider it from numerous varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!
Hello my family member! I wish to say that this article is awesome, nice written and come with almost all important infos. I’d like to see more posts like this .
of course like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the truth then again I will definitely come back again.